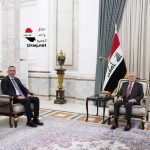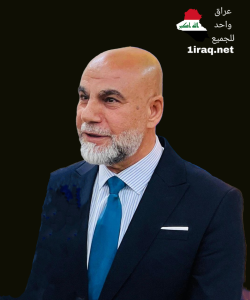عريز الدفاعي: “الناشطاتُ نُشطًا”! من المؤسف حقًا أن تُتاح حرية النشر المطلقة لكلّ من لا يُفرِّق بين الهمزة وعصا العميان
“الناشطاتُ نُشطًا”!
عريز الدفاعي
من المؤسف حقًا أن تُتاح حرية النشر المطلقة لكلّ من لا يُفرِّق بين الهمزة وعصا العميان، ثم يُقدِّم نفسه على أنه مفكر، محلل سياسي، وأحيانًا “استراتيجي”، أو عالم اجتماع، أو داعية، وأخيرًا: ناشط… أو “ناشطة مدنية”!
يفتي بما يشاء، ويظن بعد كتابة بضعة أسطر أنه بات كاتبًا وصحفيًا ومحللًا سياسيًا، ثم يضيف إلى اسمه بعد أشهر لقب “المفكر” و”الخبير”!
ومن بين هؤلاء، من أسميهن – دون تردد – “الناشطات نُشطًا”، أقولها صراحة: أنتنّ سبب في ضياع الأسر والمجتمع!
في ظلّ ثقافة الشتائم، التخوين، التسقيط، والشخابيط، وتبنّي مفهوم الحرية الغربية ممن يبنون الخراب دون أن يملكون أدوات البناء، ولا معمارية الفكر، ولا تراكمًا معرفيًا يؤهلهم لصناعة وطن.
هكذا لا تُبنى الإرادات، ولا تنهض الشعوب.
صار من حق كل عرّافة أن تلقي الحصى وتقرأ طالع الوطن، وتفتي بالحلال والحرام، وتحدّد المباح والممنوع، وتتبنّى حرية الجسد الأنثوي!
بينما تقف أمٌّ فقدت ولدها شهيدًا على باب مستشفى للرمد، تنتظر علاجًا لعينيها المبصرتين!
ويحق لمراهق فاشل، أغبر، أشعث، متروك لمقاعد الدراسة، يعيش في قاع المدينة، أن يتمايل راقصًا كقطّ في موسم تزاوجه في شباط من كل عام، أن يُغلق كلية للطب، أو مدرسة ثانوية، ويهدد المُدرِّسات بالاغتصاب!
وينبهر آخر، قرأ كتابًا لسارتر أو راسل، وتعرّف على بعض “العرّابين” في شارع المتنبي، فيخرج على فضائية مأجورة ليطالب بحقوق “المثليين”!
تهمة كانت في ما مضى كافية لهدم سمعة عائلة، وربما عشيرة كاملة!
إنه مشروع محو الأخلاق، وتحليل المحرمات، وهدم الرموز التي حمت الوطن.
فوراء لافتات الحرية المطلقة، والشعارات البرّاقة، والمدنية الزائفة، هناك محاولة لهدم الأسرة، والدين، والتعليم، والأخلاق، وكل ما هو مقدّس.
يراد أن تُصبح تقاليد الغرب معيارًا للتقدّم!
إنها عقدة “تقليد المغلوب للغالب”، كما وصفها ابن خلدون.
تستيقظ فتاة في الخامسة عشرة فجراً، وتطلب من رفيق خيمتها – الهارب من الثانوية – صحن باچة، لأنها تعتقد أن الكولاجين فيه يحفظ بشرتها… لعلّ ذلك يعيد للوطن عافيته!
ألا يفتقد الأب والأم أولادهم؟
أتساءل: من أين خرجت هذه المخلوقات التي تعبث بشوارعنا وكأنهم رهط من الوحوش انبثقوا من سراديب سحيقة؟
يرقصون على جثث الأطفال، وخلفهم حرائق تلتهم الشوارع والبنايات، والموسيقى تصدح من جحيمٍ لا يُطاق.
أنا مع التظاهرات، عقلًا ووسيلة، لكن المفارقة أن هؤلاء لا يرون أن عدوهم هو المحتلّ الأمريكي، بل يرونه في عمامة المرجع الذي قاد الجهاد، منذ أهزوجة محمد سعيد الحبوبي التي ردّد صداها تراب الكوت، حين تصدّى للبريطانيين قبل أكثر من قرن، وأسر الجنرال تاوزند!
هو المرجع الثمانيني، الناسك، الذي يعيش بيننا في بيت خَرِب في النجف الأشرف، بلا جيش ولا سلطة، وهزم بفتواه مخطط داعش.
الدين هنا – والعمامة المقصودة – هو التشيّع تحديدًا.
لم نجد أحدًا اعترض على سلطاتٍ دامت أربعة عشر قرنًا، كانت قرينًا للإرهاب، والعهر، والمجازر، والجواري، والمخصيّين.
إنها مهزلة “الحرية” التي افتقرت للضوابط، عند شعوب خرجت تواً من اسطبلات التدجين، ومن قرونٍ من الركوع للحاكم بأمر الله، والخليفة، والسلاطين، وسحرة البلاط، والعبودية، وأحواض التيزاب، والمقابر الجماعية… لتعيش الآن عصر “الليبرالية الأمريكية”، ونهاية التاريخ، والدين، والقيم، وتُقاد لتأسيس أكثر الأنظمة فسادًا، تنفيذًا لبروتوكولات “حُكّام أورشليم”.
نجح الغرب في بناء حضارة مادية، لكنه خسر روحه، وترابطه الأسري، وطمأنينته.
ملايين منهم وجدوا الخلاص في المخدرات، أو الشذوذ.
الدين، القيم الأخلاقية، العرف – هذا الثالوث هو درع الأمم – ويضاف إليه الهوية الثقافية والحضارية.
بدون كل ذلك، تُنتهك الأعراض، وتتفكك الأسر، ويُهدم القانون والحياء، ويُختزل الإنسان إلى غريزة بهيمية.
وحين تسقط تلك القيم… ينهار السقف على رؤوس ساكنيه.
في رواية “لاندري جيد”، يُقدِم البطل على دفع رجلٍ من باب قطار منطلق فقط ليثبت أنه “حرّ” في أن يفعل ما يشاء… دون أن يكترث بجسد الضحية الذي مزقته العجلات الحديدية.
ليس كل شعارٍ للحرية، في وقت مضطرب، هو خيرٌ للأمة.
كم من كلمة حق أُريد بها باطل!
وكم من شراب حلوٍ كان سمًّا نازفًا!
انتبهوا لأولادكم وبناتكم… فأنتم مسؤولون عنهم، ومساءلون أمام الله.
لا تفرّطوا بهم…
عودوا إلى سترٍ حصين، وسراجٍ منير، وصراطٍ مستقيم… قبل فوات الأوان.
اللهم اشهد.

نوفمبر 2019
Share this content: